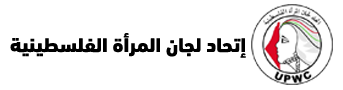بالبرتقالي: كسر قانون الصمت

كتبت ريما نزال
يقول مسح العنف في المجتمع الفلسطيني الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء 2019، إن 40% من المعنفات، من فئة المتزوجات أو ممن سبق لهن الزواج، على علم ودراية بوجود مراكز ومؤسسات مختصة في الحماية من العنف في مختلف المحافظات. إلا أن الصادم في الموضوع أن 61% ممن تعرضن للعنف فضلن السكوت، في الوقت الذي توجهت 1% من المُعنفات لطلب المساعدة النفسية أو القانونية من المراكز، إضافة إلى ذهاب ما نسبته 1% من المعنفات إلى أحد مراكز الشرطة أو وحدات حماية الأسرة طلباً للمساعدة أو الحماية.
العنف الأسري، هو الظاهرة الأكثر انتشاراً في العالم بأسره على صعيد الأماكن التي يُمارس فيها العنف ضد المرأة، لكن الاختلاف بين العنف في منطقتنا العربية وباقي المناطق في تبعاته. وبالتالي أصبح الشغل الشاغل للحركات النسائية الكونية، مع أخذ الاعتبار إلى أن البيت هو المكان الذي يشهد النسبة الأعلى من جميع أشكال العنف، بينما يُفترض به توفير الحماية والأمان لجميع أفراده، وخاصة النساء والفتيات اللواتي يقع عليهن العنف بشكل أوسع من باقي الشرائح والفئات، ليتحول المنزل إلى المكان الأكثر تهديداً وخطورة على حياتهن.
لقد كشفت الإحصائيات العالمية النقاب عن تعرض واحدة من أصل كل ثلاث نساء وفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، وما يثير الحفيظة أن أغلب الممارسات العنفية قد تمت على يد الشريك الزوج، وأن 50% من النساء قد قُتلن على يد أزواجهن وعائلاتهن في عام 2017، في الجرائم التي تُرتَكب على خلفية ما يُسمى «بجرائم الشرف».
تتأثر المجتمعات الى حد كبير بالبنية الفكرية السائدة والقيم ذات الهيمنة الذكورية، لذلك تحرم النساء من حقوقهن الأساسية ونقص في تمثيلهن في عمليات صنع القرار على الرغم من تبني الدولة تسمية المساواة والتمكين كأحد أهم هدفين من أهداف الإنمائية للألفية الثانية. بينما على أرض الواقع ما زالت السياسات الحالية تقلل من الأهمية الحيوية للمساواة، وحياة النساء متروكة للتهديد من قبل الأفكار المحافظة.
وهذا لا يعني استثناء النساء من أنهن قد يكنَّ قمعيّات أو مُعَنِّفات للرجال ولغيرهن من النساء؛ بل يعني أن المجتمع محكوم بنظام تقليدي وأبوي، نظام السيطرة والهيمنة الذي يولد العنف ويديمه، وأن الهيمنة تنتقل بسلاسة إلى الحياة اليومية على شكل قواعد وقيم نعتاد عليها ولا يمكننا التعرف عليها كاعتداء وعنف يمارَس من الطرف القوي المتنفذ على الطرف الضعيف الذي يقع تحت السيطرة.
قانون الصمت عن العنف الأسري من القوانين غير المكتوبة، إلا أن الالتزام بمنطقه وأسبابه مُطْبق بإحكام. تحت ذريعة ثقافة العيب والعار وعدم إخراج المواضيع الأسرية إلى العَلَن، كمواضيع شخصية ضمن مفاهيم الثقافة السائدة ومفهوم ملكية الأسرة لأفرادها وخاصة الإناث منهن.
يحيط بالعنف حلقات من الصمت، ثقافة تساعد في اعتباره مسألة خاصة وخلف البواب المغلقة، لقد ساهم قانون الصمت واستمراره لأجيال كأحد الأسرار داخل الأسرة بينما ديناميات العنف تتفاعل. الصمت من أجل أن لا يُعاقبن ويحرمن من حقوقهن، الصمت على عدم حصولهن على ميراثهن، الصمت على الاستيلاء على أملاكهن وأموالهن ورواتبهن، الصمت على العنف النفسي والجسدي والجنسي. ليصبح الصمت على الانتهاك والظلم هو القاعدة، ويصبح السكوت قيمة ايجابية بسبب القبول الاجتماعي لها، كما يسهم نقص الوعي في إدامة الشعور بالخجل من التقدم بالشكوى.
التساهل الاجتماعي جعل إلحاق العنف والأذى جزءاً من الحياة الاعتيادية اليومية، جعل العنف من المسائل العادية بما ساهم في إحاطتها بالصمت والخوف من الجهر بها خشية من العقاب، والتهديد بالضرب والحرمان والإهمال. وأصبحت المرأة جزءاً مساهماً في تدعيم السلطة الأبوية من خلال الامتيازات التي تمنحها الأمهات لأبنائهن الذكور، لدرجة تورط الأمهات في جرائم الشرف.
العنف الأسري مشكلة عالمية تم إخفاؤها لأجيال، ومعالجتها لا يمكن ان تتحقق سوى بقلب الأمور رأساً على عقب باتجاه التغيير، تلعب فيه المؤسسات النسائية وحلفاؤها دوراً رئيسياً أقوى من الهيمنة والسيطرة عليه، ضمن برنامج وأولويات تبدأ بتحسين وضعية عامة للنساء من خلال معالجة العنف الاقتصادي -الحصول على الإرث والممتلكات وحق العمل المتساوي- كونه أكثر أشكال العنف إلحاحاً ومركزية، فاستقلالية النساء الاقتصادية شرط رئيسي لكبح العنف، لأن فقر النساء عامل رئيسي في قبول العنف.
وبالتوازي مع مجابهة العنف الاقتصادي لا بد من الغاء الطابع التمييزي للتشريعات في قانون الأحوال الشخصية وتشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، فتغيير التشريعات يعطي إشارات حقيقية للمجتمع بإلغاء الممارسات القديمة ضد النساء المعيقة للتقدم والتطور، كما يؤثر على الممارسات والمواقف الاجتماعية والثقافية التي تسمح بتبرير العنف.
وختاماً وليس أخيراً، لا تستقيم العملية ولا تتحقق النقلة نحو التغيير؛ دون التطرق للدور الحاسم للتربية والتعليم والاعلام، وأهمية التصدي لتكريس الصور النمطية، من خلال منح المعرفة بالحقوق وفتح العقول على المنظور التنموي بالحقوق والمسؤوليات المتساوية والتركيز على الشباب حتى لا يقلدوا سلوكيات آبائهم.