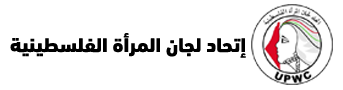الحوار المطلوب حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

كتبت ريما نزال
انشغلت المدينة بأمر الهجوم المنهجي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي سبيل ذلك تم تجيير وتجهيز الخطب المنبرية وتجنيد الإعلام الاجتماعي، كما تحركت العشيرة للدفاع عن مصالحها ضد الاتفاقية والمراكز النسوية، والمدهش في الهجمة التوحد الحاصل ضد الاتفاقية بين الخصوم السياسيين التقليديين بالمعنى الاجتماعي، كما طفا على السطح الخلاف في المؤسسة الرسمية وتنازع الصلاحيات بين المؤسسة السياسية والدينية حول الإمساك بعملية مواءمة الاتفاقية، متلاقياً مع القوى السلفية الجاهزة لاستكمال مهمتها في إثارة المشاعر الدينية وإشراك العامة في الصراع الدائر لحسم المرجعية.
العملية الممنهجة وُظِّفت لخوضها الأدوات المعتادة، التأويل والقراءة المغلوطة «التهويشية»، وتقويل الاتفاقية ما لم تقله، وحجر أساس التحريض والتجييش بتوجيه الاتهام لبنودها بأنها ضد الدين، تغريب الثقافة واستيرادها والمساس بالخصوصية الثقافية من خلال المرأة، خلخلة وحرف الأسرة العربية وتفكيكها! رغم أن بنود الاتفاقية مصاغة بشكل فضفاض لكونها تخاطب الدول المختلفة وتتسع لخصوصياتها الثقافية المحلية.
المعركة المفتعلة من قبل الاتجاهات الأصولية اختبرت في أكثر من محطة، وإن كان ثمة استخلاص فإنها تؤكد أننا لا نحسن إدارة خلافاتنا قاطبة بجميع عناوينها، السياسية والفكرية والاجتماعية، جميعها قد انتهت الى طريق غير نافذ. لا يوجد مصطلح الحوار والتوافق في الموسوعة الفلسطينية، ولا نضع في اعتبارنا تفهم الزوايا والاعتبارات المختلفة للفئات والشرائح والطبقات، ولا نقيم وزنا للتعددية والتنوع الاجتماعي والسياسي في المجتمع، الجميع يريد أن يصطبغ المجتمع بلونه ومواقفه وأن يتجانس الجميع تحت راياته ورأيه، قسراً.
فتح الحوار الديمقراطي والموضوعي والمباشر حول جوهر الخلاف ليس خياراً فلسطينياً، حوار فعّال من أجل فهم الوضعية التي تنطلق منها جميع الأطراف، ولو في حدودها الدنيا، بل الخيار المفضل في الذهاب إلى إطلاق نار التكفير والتخوين وإطلاق الأحكام المسبقة وموضعة الرأي الآخر المختلف في قوالب الشيطنة، واستخدام وحشد وتجييش جميع الأدوات من أجل إخراج البعض عن الصف الوطني تارة.. والدين تارة أخرى.
سحب النقاش نحو المربع الديني فقد مصداقيته، فإن كنا نتحدث عن «سيداو» فلم تمس الاتفاقية بالدين في أي بند من بنودها، وكل ما فعلته أن حددت الإشكالات المجتمعية الممارسة في المجتمعات والقائمة على خلفية التمييز الممارس ضد المرأة، ضمن عناوين واضحة من العنف إلى منع المشاركة السياسية والإجحاف في قطاع العمل، وعلى صعيد التمييز في الصحة والتعليم وفي حق المرأة في منح الجنسية لأبنائها وفي قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والولاية، من أجل تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في النظام الأساسي قبل المصادقة على الاتفاقية، بل كان ضرورة للتعبير عن هوية الدولة الثقافية واعترافها بالحقوق والحريات للنساء كما الرجال في الميادين المختلفة والتعامل معهن على هذا الأساس وبنفس الأسلوب، وجميعها حقوق لا تتعارض مع الدين.
الأزمة المثارة على خلفية الاتفاقية تعيدنا اثنين وعشرين عاما إلى الخلف، حين قام الأصوليون واتجاهات الإسلام السياسي بافتعال معركة ضد ما عرف حينذاك «البرلمان الفلسطيني الصوري» الذي ركَّز مطالبه على حق مشاركة المرأة في وضع القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحياتها، بادئاً بعمل مسح لأشكال التمييز في القوانين النافذة، المصرية والأردنية، من أجل توحيدها وفلسطنتها.
لم تكن «سيداو» مطروحة آنذاك، وارتفعت حرارة المشهد حول من يملك الحق في وضع القوانين وخاصة قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات، معتبرين أن الحق محصور «بأصحاب الاختصاص، ورغم تطور واتساع المفهوم تم وضعه ضمن قائمة «التابويات».
التاريخ يعيد نفسه، فالصراع والتنازع على الصلاحيات والمصالح السياسية والوظيفية قد احتدم بسبب الشروع في عملية المواءمة ومرجعيتها التي وُظِّف الدين في خدمتها، وربما تكون الانتخابات في بنك الأهداف. لم نر أن الفوائد البنكية قد استفزت مشاعرهم الدينية باعتبار الفائدة مرادفة «للربا» الذي جاء في النص المقدس، ولم نر او ترتفع الحميّة على حرمان المرأة من ميراثها الشرعي، حيث تختفي الاجندات التي تستخدم الدين عند المصالح وتبرز عند قضايا المرأة، يا لمحاسن الصدف؟
رب ضارة نافعة، سابقاً ولاحقاً. خرجنا من أزمة البرلمان الصوري عام 1997 بمكسب تثبيت حق المرأة في وضع القوانين، ووقع الاتفاق في مقر المجلس الوطني في نابلس بمشاركة الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير مع حركة حماس وأكاديميين وقيادات دينية وممثلات البرلمان الصوري.
الهجمة الممنهجة على «سيداو» لا يمكن طيّها دون فتح الحوار حول الإصلاح القانوني على مصراعيه، من خلال مبادرة الحركة النسائية مع حلفائها لإطلاق الحوار الموضوعي بين ممثلي مختلف القوى دون تحفظ على طرف، ونقل الحوار الى المجتمع بشفافية ضمن أدبيات الحوار الديمقراطي والحضاري، دون تكفير أو تغليب الذات في قراءة الاتفاقية، بل الذهاب إلى نقاش فكري حول هوية الدولة التي نريد، دون ترهيب أو تهريب أو قمع الافكار بسبب الارهاب الممارس من القوى الأصولية، فنحن مجتمع تعددي ومتنوع ومن الطبيعي أن نختلف ونتباين، لكن الشاذ هو الطريقة والآليات المستخدمة التي تبث التفرقة والكراهية والتخندق والتشهير والعبث بالأمن الاجتماعي، دون وجه حق.
النقاش البديل المطلوب هو الانطلاق من الواقع ووضع التصورات لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الإشكالات على الأرض، وهي كثيرة ومتفاقمة، وعلاجها لا يتم بدفن الرؤوس في الرمال المتحركة. مواجهة مشاكلنا الجدية كارتفاع العنف المجتمعي بجميع أشكاله في الشارع والمدرسة وأماكن العمل وخاصة ارتفاع العنف الأسري في المنازل. لنجد الحلول لمشكلة الأطفال الذين بلا نسب والتي لا يمكن التنكر لوجودها ومعظمها للأسف نتيجة سفاح المحارم..هذه مسائل لا يتم معالجتها، بل يسعى من يهاجمون النساء بسبب وبدون سبب الى تجاهلها، أعتقد أننا جميعاً مقتنعون بأن المجتمع يشهد تحولات وتغيرات في قيمه وأخلاقه..
لنذهب إلى كلمة سواء، التباحث في إشكالية البطالة في صفوف النساء وخاصة الخريجات وعدم تصويرها كما لو كانت على حساب عمل الرجال، بل النظر لها كحق من حقوق المواطنة..لنتباحث في قضايا جوهرية لها علاقة برفع مستوى الأسرة وتعبئة الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالعملية التنموية…أما الردح وإطلاق الأحكام واستخدام الدين بطريقة انتهازية فهذا لا يوصل مجتمعنا إلى أي من أهدافه، سواء كانت وطنية او اجتماعية تنموية، بل سيدفع المجتمع الى منزلق خطر نحن في غنى عنه راهناً ومستقبلاً.
وللمقال بقية